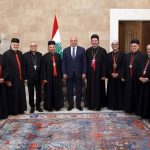تكاد لا تغيب الإبتسامة المتواضعة عن ثغرها، حتى وهي متشحة بالسواد على اثنتين: والدتها المقاوِمة وابنة شقيقها التي رحلت قبل أشهرٍ على عجل. منزلها الجبيلي مليء بالحبّ والتواضع وبكثير من الميداليات والذكريات والتحديات. هي وصلت للتوّ من حفل تكريم عالمي وتغادر بعد العيد الى حفل عالمي يناصر العدالة. لا تتعب ولن تتعب.
هي ابنة كفرعبيدا. والداها يوسف وماري اللذان أنجبا ثمانية أولاد، أربعة صبيان كبيرهم أنطوان وأربع بنات صغيرتهم أنطوانيت وتقول: «كنت آخر العنقود. تزوجوا جميعاً وبقيت مع «بيي وإمي» ويوم «صار اللي صار» إنزوى والدي لكن والدتي قاومت وقادت السفينة». فماذا في تفاصيل ما صار؟
تحضّر القهوة. تفوح رائحتها زكية. نشربها حتى آخر شفة ونحن ننصت الى المرأة الصلبة، ذات الشعر الشديد السواد والعينين الوقادتين: «كنت خجولة جداً. كنت الفتاة الصغرى في بيتنا. كبرتُ وأنا أرى والدتي ترتدي الأسود حزناً على شقيقي ميشال الذي استشهد العام 1976. لم يخفت إيمان والدتي يوماً على الرغم من كل ما واجهتنا من ظروف وصعاب. وأتذكر أنني يوم وضعوا الكلبشات في يدي قلت لها أريد قميصاً طويلا لأخفيها. إنها تضايق معصمي. أجابتني: لا تبالي. هذا شرفٌ على معصم فتاة بريئة.
تنظر أنطوانيت الى الأفق. تمسح دمعة حاولت عبثاً حجزها بين مقلتيها وتابعت راسمة ابتسامة: «والدي كان صياد سمك ووالدتي تخبز. حياتنا كانت بسيطة جداً لكنها مليئة بالحب والتعاضد. كنت أهوى لعب الـ «فولي بول» (الكرة الطائرة). أمي كانت شخصاً غير عادي. فقدتها. كانت صديقتي ورفيقتي وأختي وأمي. إنها مثال لكل امرأة. ربتنا على الإيمان والتواضع وألّا نكذب أو نسرق أو نشهد زوراً. هي تعاليم وَضَعَتها في طبقنا اليومي».
تزوج الأخوة والأخوات وشقيقها جان سافر. حصل إنفجار كنيسة سيدة النجاة وكان يوم أحد. وتقول «منذ ذاك اليوم لاحت مكيدة تُدبر للقوات اللبنانية من خلالنا. وفي 21 آذار من العام 1994، يوم عيد الأم، بينما كنت أتناول القهوة مع والدتي في المطبخ متأملة وجهها الذي غزته التجاعيد والعذاب، دقّ الهاتف. كان عنصراً من جهاز مخابرات الجيش في جبيل، طلب مني أن أستعدّ لأن موكبا سيأتي لاصطحابي الى بيروت للتحقيق معي. وقبل أن يرموني في السيارة لمست بأطراف أصابعي قدمي مارشربل. وقبلت أمي. أخذوني الى وزارة الدفاع. أجلسوني على كرسي وعصبوا عيني. وكل من تكلموا معي سألوني عن شقيقي جان. بعد ساعات أدخلوني الى غرفة فارغة إلا من غطاء مرمى على الأرض. شعرت أنني في كابوس تحت تأثير التنويم المغناطيسي. لم أفهم ماذا يحدث. وأيقنت حينها أنني عالقة في دوامة الجنون.
إلتقطوا صوراً لي كتلك التي تؤخذ للمجرمين. لطموا رأسي مراراً بالحائط. عذبوني على البلانكو. قرأت على أحد الجدران عبارة كتبها سجين: السجن للكلاب وأنا من البشر. لم أعرف لماذا كل ذلك. وما هو الذنب الذي اقترفته؟ سألوني عن شقيقي ورموني كدمية في سجن وزارة الدفاع. وبعد أسبوعين سمحوا بزيارة والدتي. لم نتكلم بل بكينا معاً. دموعنا كانت كل ما لدينا لنقوله. ويومها زارني كاهن عرفت لاحقاً انه رئيس أبرشية جبيل آنذاك المطران بشارة الراعي. سألني عن صحتي وطلبت منه ان يصلي لي كي يمنحني الرب نعمة الصبر».
جلجلة المعتقل
قبل أفول شهر نيسان إقتادوني الى غرفة حيث وضعوا رجلا معصوب العينين. كان سمير جعجع. كل ما أرادوه هو الإذلال لكنني إستمديت منه قوّة لا ضعفاً. ويوم زارتني المحامية سيدة حبيب سألتها: لماذا أنا هنا؟ اجابتني بإشارة وهي تهز الصليب الذي على صدرها. لم أفهم إلا لاحقاً أنني هنا في قضية تفجير الكنيسة.
في السادس من أيار، بعد ستة وأربعين يوماً من العذاب، خرجت أنطوانيت شاهين من سجن وزارة الدفاع. عادت الى جبيل. هي حرية مغموسة بالدم لأنها حينها عرفت أنها أوقفت في قضية الإعتداء على الكنيسة. أتتصورون هذا؟ تردد ذلك بعد ثلاثين عاما غير مصدقة. كان شهر أيار. صلّت مسبحة الوردية ووقفت تحت رذاذ المطر ونظرت الى الورود وهي تتفتح واحتضنت والدتها وتنشقت رائحة الحياة مجدداً منها. شعرت إبنة الثانية والعشرين (هي من مواليد 1971) بأمور ذات قيمة كبيرة كانت تعتبرها من قبل صغيرة.
ظلم بلا حدود
في صباح التاسع من حزيران قُرع باب البيت بقوّة مجدداً. كنت نائمة. طوقوا البيت. واقتادوني الى مخفر جونيه. ورأيت أمي تسقط أرضاً. سألوني مجدداً عن شقيقي جان. نفس الأسئلة: متى رأيته آخر مرة؟ أين يجتمع مع سمير جعجع ورفاقه؟ وأين؟ وأين؟ أمرهم مفوض الشرطة ان يأخذوني قائلا: أجبروها على الإعتراف. وإذا لزم الأمر أعملوا لها فروج. وهذا ما حصل. يا الله ماذا حصل. تعذبت كثيراً. ولولا إيماني لما صمدت. كنت افكر في وجه أمي وأصلي. ضعفت. أعترف. قررت أن أوقع على إعترافات لم أقلها لكن القلم سقط من يدي ولم أفعل. صرخت. رفضت التوقيع على ما لم أقترف لأنني سأحمي المجرم الحقيقي. وأتذكر أنني أول مرة رأيت فيها أمي سألتني بصلابتها: كيفك؟ أرادت أن تبدو قوية. كنت أحلم أن أقبلها. الحلم بالنسبة الى سجين مظلوم يمنحه القوة. كنت أضع إصبعي الصغير (الخنصر) من فوهة في السياج الفاصل وتضع هي أصبعها الصغير فنشعر ببعضنا. لم أخبرها عن وجعي لكنها كانت تشعر به. وكنت أسمع بكاءها وهي تغادر. دموع من وقفوا الى جانبي ظلّت سلاحي دائماً.
أرادوا إلصاق تهمة قتل كاهن بي. لم يسبق أن سمعت باسمه. أيام مظلمة كئيبة موجعة. وأصعب شيء كان شعوري بالعطش. كانوا يرمون المياه على جبيني في حين أن قلبي يشتهي نقطة المياه. فتح البطريرك مار نصراله بطرس صفير باب بكركي أمام أمي. ذات يوم جلست والدتي حافية القدمين، في الصقيع، على درج بكركي فنزل إليها البطريرك صفير بنفسه وصعد معها درج بكركي».
تتذكر أنطوانيت شاهين يوم صدر حكم الإعدام بها في السادس من كانون الثاني عام 1997: «كان يوم عيد الغطاس. كنت موقنة أنهم سيخلون سبيلي لأنني بريئة. وأمي كانت أول من نقل لي الحكم. قالت لي: شو فيي أعمل يا إمي حتى أقضي معك هنا كل العمر. كان حكماً بالإعدام مخففاً الى الاشغال الشاقة المؤبدة. دارت فيّ الدنيا وسقطتُ أرضاً وفقدتُ القدرة على المشي والكلام. كانوا يحملونني وأنا عاجزة. وكانت في كل مرة تزورني فيها امي تقول لي: متى سأسمع منك كلمة ماما؟ نقلوني مراراً الى المستشفى في حالة يرثى لها».
في تلك الأثناء بدأت جمعيات حقوق الإنسان تزورها. أيقن كثيرون أن الفتاة البريئة تدفع أثماناً باهظة عن ما لم تقترفه: وائل خير وناديا بويز وهدى قارة… اسماء تكررها أنطوانيت شاهين معترفة لها بجميل كل العمر. سألناها: لماذا أنت؟ أجابت: «كان المطلوب كبش محرقة».
كان المساجين يكتبون كل يوم رقماً يحذفونه من أيام السجن وصولاً الى الحرية أما هي فكانت تضع علامة «إكس» لأن سجنها أبدي. خالته سيكون أبدياً. تتذكر منظمة العفو الدولية وزيارات رئيسها السوداني عبد السلام سيد أحمد الذي آمن ببراءتها. وجمعية ACAT التي أصبحت لاحقاً سفيرتها. بدأت تهطل عليها رسائل الدعم من العالم كله من اشخاص لا تعرفهم. خسرت حريتها لكنها لم تخسر يقينها بأن هناك ساعة حرجة يبلغ فيها الباطل ذروة قوته ويبلغ الحق فيها أقصى محنته، لكن الثبات في هذه الساعة الشديدة هو نقطة
الله كبير… العدل قليل
كان شعاع الأمل ينبعث فيها من كل دفعة رسائل تصلها. تابع المحامي بدوي أبو ديب قضيتها. المطران غي نجيم رافق محنتها دائما بأمر بطريركي وبثقة منه ببراءتها. قصد منزل عائلة الكاهن الذي قتل في عجلتون فأسقطوا الحق الشخصي عني. أما سعد جبرايل الذي أدلى بشهادة كاذبة عني بفعل تعذيبه فأرسل لي رسالة سماح. غفرت له. وغفرت الى كل من أساء إلي وظلمني. إستأنف الحكم في محكمة التمييز في بيروت. شعرت ببعض الأمل لكن كل ما أمكنني فعله هو أن أجاهر ببراءتي. أضيئت الشموع على نيتي، من مسلمين ومسيحيين، في كل العالم. وأتت ليلة 23 حزيران عام 1999. يوم صدور حكم الإستئناف. كان قد مضى أكثر من خمسة أعوام على سجني. كنت خائفة كثيراً. مرّت الدقائق كأنها أشهر. وفي تمام الساعة الحادية عشرة والنصف استدعيت الى غرفة الإستقبال. كانت أمي. رأيتها تعبة منهكة والتجاعيد بصمت بقوة وجهها وظهرها منحن. قالت لي: لا شيء بعد. وعند الساعة الواحدة سمعت مديرة السجن (وهي مسلمة تعاطفت معي كثيراً) تردد: هل هذا أكيد؟ هل هذا أكيد؟ سمعتها تقول: براءة براءة. شعرت بعناق الكثيرين فرحت أصرخ: الله كبير الله كبير…الله كبير. العدل قليل والظلم أكثر… لكن الله أكبر. ولدتُ من جديد. خرجت حرّة. خرجتُ بجرم البراءة. لكن، ماذا عن لحظات الخروج الأولى الى الضوء؟ تبتسم أنطوانيت وهي تمسح في هذه اللحظات دمعتي فرح: «ركبتُ السيارة مع اهلي وقال لي شقيقي أن عبد السلام سيد أحمد يريد أن يكلمني. سمعت صوته يقول: ألو ألو… لم أفهم من أين يصدر الصوت. لم أعِ ولادة الهاتف الخليوي وأنا في السجن. أمسكته بالمقلوب. وضحكنا لذلك لأول مرة من زمان. وصلتُ الى جبيل. أجراس الكنائس كانت تقرع. عائلتي الحلوة كانت تنتظرني كاملة. عائلتي سبب صمودي. ووالدي كان جالساً يبكي فرحاً. طلبتُ زيارة المطران غي نجيم قبل ذهابي الى البيت وهو الذي صرخ دائماً في وجوه الكثيرين: أنطوانيت فتاة بريئة. هو قديسي الحيّ. هو من زوجني لاحقا ومن عمّد إبنتي جويا وإبني رواد وهو من أحيا جنازة والدتي. رأيته في عشقوت ومنذ تلك اللحظة سلمته حياتي. هو مرشدي الدائم.
خرجت أنطوانيت شاهين من وراء قضبان الظلم وأمامها خياران: المكوث في البيت أو حمل رسالة كل مظلوم والنضال في مجال حقوق الإنسان وتقول: «إخترت النضال. وانطلقت مسيرتي الجديدة لم أنس فيها كل من وقفوا الى جانبي في محنتي. لم أنس الوجوه المظلومة وراء القضبان الحديدية الموصدة على أشخاص منسيين.
ماذا عن جميل السيّد؟ هل رأته؟ هل تريد ان تقول له شيئاً أي شيء؟ ترفض الإجابة وحتى ذكر إسمه. لكنها تقول: خرجت بلا حقد. ربنا أعطاني نعمة الغفران. وهناك أسماء شطبتها من ذاكرتي. الحقد سجن آخر «وشو حلو يلي بيتحرر منو وشو حلو الحب وشو بشع البغض والظلم».
مرّت الأعوام، خمسة وعشرون عاماً، وهي في مسيرة لا تهدأ. زارت فيها العالم وانحنت عرفاناً أمام كل من ساندها ولو بدمعة. وتقول: «إخترت الدفاع عن حقوق الإنسان التي هي لكل العالم، لا دين لها ولا لون ولا بشرة. بتّ رسولة ضدّ التعذيب والإعدام والظلم» تضيف: «قد ينسى الإنسان من ضحك معه لكنه لن ينسى من بكى معه». وهنا تكرر أسماء بينها وائل خير وستريدا جعجع وبدوي ابو ديب والبطريرك صفير وأصدقاء وصديقات. هي لا تريد ان تنسى أحداً. هي تريد ان تذكر الجميع إسماً إسماً.
في شهر تموز عام 1999 تلقت أنطوانيت رسالة من منظمة العفو الدولية تدعوها الى زيارة مقرها في لندن. طلبت أن ترافقها والدتها ماري. وفي تشرين الأول استقلت معها الطائرة الى لندن. وهناك التقت ملاكها الحارس عبد السلام سيد أحمد وآخرين. عادت تتآخى مع أشعة الشمس قلباً وجسداً. ووصفت بسفيرة المضطهدين. عادت وذهبت الى الفاتيكان وأهداها أحد الكهنة مسبحة من دون صليب قائلاً لها انها تحمل الصليب في داخلها.
مفاتيح مدن… وقلوب
خمسة أعوام ولد فيها المسيح خمس مرات حسب الروزنامة الطقسية لكنه ولد فيها كل لحظة وتكة. ولولاه لما صمدت. وتقول: «أدركتُ أن لديّ دوراً جديداً أقوم به وهو نصرة المضطهدين. تلقيت رسالة من جمعية «معاً ضد عقوبة الإعدام» دعتني فيها الى زيارة ستراسبورغ للمشاركة في مؤتمرها العالمي. إلتقيت كثيرين. إلتقيت أشخاصاً يرفعون الرأس وقلوبهم كانت معي. واستلمتُ لاحقاً رسالة تعلمني أن وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية قدمت لي منحة تعليم لدراسة الحضارة الفرنسية واللغة الفرنسية في جامعة السوربون. حصلتُ على مفاتيح مدن ومنها مفتاح «سارلا» وهو أحبّ هدية الى قلبي. رأيتُ فيه مفتاحاً لكل القلوب المنكسرة. إنه مفتاح رسائل من فكروا بي أيام سجني فشرعت أمامي أبواب الحرية. حملتُ عصا الحج وجلت في كل أنحاء فرنسا مدلية مرات ومرات بشهادتي». وتعود أنطوانيت لتذكر أشخاصاً وقفوا الى جانبها: مدام ميتران (دانيال ميتران) وأحمد وسيمون عثماني…
أحيانا ينتاب أنطوانيت شاهين أنها سجينة قصتها. فهل سيأتي يوم تنساها.؟ تقول: «أعترف أنني في كلِ مرة أتكلم عن مراحل الجلجلة أشعر بالضيق. وما أدركه تماماً أنه لقبري لن انسى من ساعدني. الحقّ ربح. ورسالتي اليوم ألّا يعيش أحد الظلم الذي عشته. كُرّمت في تونس والمغرب وكل أوروبا وكندا وأميركا.
ماذا عن لقائها الأول مع البطريرك صفير؟ تجيب: «أتذكر أنه حين رآني قال لي: مش إنتي كنتي محبوسة إمك كانت ورا القضبان». وماذا عن أول لقاءٍ لها مع من رأته معصب اليدين مقيّد اليدين في وزارة الدفاع؟ ماذا عن لقائها بسمير جعجع؟ تجيب: «حصل اللقاء في منطقة الأرز. جلست معه مطولاً. كان هناك كلام كثير يجمعنا. فهمني وفهمته ومسح دموعي. كان اللقاء مؤثراً جداً».
ننظر الى الميداليات في الأرجاء. أسماء منظمات عالمية تؤمن بالحقّ والعدالة والإنسان كرمتها. وهناك درع باسم وزارة الإعلام قدمه لها الوزير السابق ملحم رياشي له حنين خاص في قلبها: «هذا التكريم نلته على نفس المنبر الذي وقف وراءه جوزف سماحة يوم حلّ القوات واتهمني بما أنا بريئة منه».
تزوجت أنطوانيت شاهين من جوزيف صليبا. تلمع عيناها حين تتكلم عنه: «هو شقيق صهرين لي (الشقيقات الثلاث تزوجن ثلاثة أشقاء). هو مسح دموعي. إنه زواج عقل وقلب وبيننا إحترام كبير. لم يكن قرار زواجي سهلاً بعد كل العذاب الذي مررت به لكنه مع جوزيف كان أكثر سهولة. واليوم لا أجد كلاماً لأعبّر له عن حبي. إنه رفيقي وأخي وحبيبي وزوجي والداعم لي من كل النواحي. هو يقول لي دائماً: أنا حدّك». يوم زواجهما باركه البطريرك صفير قائلا: «إنا نسأل الله أن يبارك قرانكما (…) ونأمل أن هذه المرحلة الجديدة من حياتكما ستضعانها تحت حماية السيدة العذراء وهي التي حمتكما وأنقذت إبنتنا أنطوانات (أنطوانيت) من المحنة القاسية التي تعرضت لها وألهمت من بيده الأمر لاستجابة صوت الضمير وإحقاق الحقّ لإظهار براءتها مما نسب إليها زوراً».
العيلة الجديدة
لأنطوانيت وجوزيف ولدان: جويا ورواد. أصبحا اليوم في الجامعة وتقول: «أفتخر بهما. جويا مناضلة شابة ورواد شاب مليء بالحماسة»… تستعدّ أنطوانيت شاهين اليوم لاستقبال الطفل يسوع في منزلها الذي يتفيأ بأشجار الحمضيات. هي إمرأة إستثنائية عجنها العذاب فخرجت منه صلبة في النضال، مرهفة الإحساس، تأبى الظلم، ومدافعة شرسة عن حقوق الإنسان.
هي ابنة حقبة تَسَلط فيها من تسلط وحكم عليها القاضي حاتم ماضي بالإعدام وأعطاها القاضي أحمد المعلم البراءة. هي خرجت موقنة أن لا الطائفة ولا الجنسية ولا اللون تحدد جوهر الإنسان بل إيمانه بالحقّ الإنساني. أنطوانيت شاهين إنتصرت وفي قلبِها صليب كبير كبير حولته الى حبٍّ وسلام.