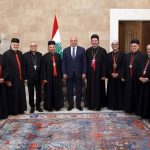التركيبة المجتمعية في لبنان، وتالياً السياسية، بقدر ما هي ميزة فتحت لهذا الوطن الصغير آفاق النهضة في كل جوانبها، لكنها في الوقت ذاته تركيبة تحتاج إلى صون دائم، لأن أي إخلال بمتطلباتها يؤدي إلى أسئلة طابعها سوداوي وتشاؤمي، فوجود لبنان بـ “دولته الحالية” مرتبط بدوره، فإذا فقد الدور طرحت أسئلة وجودية.
والتركيبات ذات التعقيد المجتمعي والسياسي تحتاج إلى ضبط دقيق للمفردات حتى لا يتحول التعدد إلى تشرذم وتناحر، وفي مجال ضبط المفردات هناك من يخلط بين مفهومين تجليا بقوة خلال الفترة التي مهدت ثم سادت، بعد ما نال لبنان الاستقلال عام 1943، فـ “الميثاق الوطني” ليس المرادف السياسي لـ “الصيغة اللبنانية”، فالمفهوم الأول يُعنى بإرادة العيش المشترك التي ارتضاها اللبنانيون المسيحيون والمسلمون بكل طوائفهم التي يبلغ عددها نحو 18 طائفة، أما الصيغة فهي النظام السياسي الذي يجب أن يراعي دوماً “الميثاق التاريخي”.
لذا فإن بقاء الدولة مرتبط بثبات الميثاق، بينما الصيغة يمكن ويجب أن تبقى متحولة، ومنذ إعلان الميثاق لم تتوقف القوى السياسية عن اقتراح الصيغ السياسية، وغالبيتها صيغ سياسية تحت سقف “الميثاق الوطني”، وبالفعل فمنذ الاستقلال عرف لبنان صيغتين سياسيتين تكرستا بالدستور، هما “صيغة 43″ التي حلت محلها بعد الحرب الأهلية الصيغة الحالية المعروفة بـ”صيغة اتفاق الطائف”.
ولأن الميثاق طابعه وطني وتاريخي، فقد لعبت المرجعيات الدينية دوراً في التأكيد عليه، كلما شعرت بأن اعتراض القوى السياسية على “الصيغة” يلامس “الميثاق” ويهدد متانته، وهذا كان دأب المرجعيات الإسلامية والمسيحية التي بقدر ما كانت تتفهم وتؤيد القوى السياسية التي تنضوي تحت جناحها الروحي، اتخذت على الدوام دور صمام الأمان لعدم انفراط “الميثاق” إذا تمادت الأطراف في غلوها السياسي.
ومن الأمثلة أن دار الفتوى السنيّة وبشخص المفتي حسن خالد الذي اغتيل عام 1989، أراد أن يكون تغيير “الصيغة” تحت سقف اتفاق وطني لبناني لا يهيمن عليه النظام السوري الذي كان يفرض على البيئة السنيّة شخصيات يحركها كالدمى، وبعد اغتيال المفتي حسن خالد جاء اغتيال رفيق الحريري بعد 16 عاماً في الإطار ذاته.
على الساحة المسيحية شكل البطريرك الماروني نصرالله صفير الغطاء المسيحي المهم لقبول المسيحيين بـ “دستور الطائف” الذي حد من بعض صلاحيات رئيس الجمهورية الماروني، ثم أخذ “الميثاق الوطني” بعداً عالمياً وخصوصاً بعدما جاء صوت الفاتيكان حاسماً في الموقف الشهير للبابا يوحنا بولس الثاني الذي قال إن “لبنان أكثر من وطن، هو رسالة حرية وعيش مشترك للشرق والغرب، لبنان هو أكثر من وطن، أكثر من بلد، إنه رسالة، رسالة العيش المشترك السوي بين المسلمين والمسيحيين، ورسالة للغرب الأوروبي والأميركي مثلما هو رسالة للشرق العربي والإسلامي، أي أنه رسالة عالمية”.
هذا في ما يختص بالسنّة والمسيحيين، ولكن الأمور ليست على هذا النسق عند الشيعة، فمنذ الانقلاب الذي نفذه “حزب الله” على “الطائف”، اختطف “الثنائي الشيعي” المرجعية الروحية للطائفة وعطل دورها حد فرض القطيعة مع المرجعيات الروحية الأخرى، ولم يعد يوجد صمام أمان لـ “الميثاق” يمسك به “المجلس الشيعي الأعلى” أو دار الإفتاء الجعفري ممثلة في الشيخ أحمد قبلان الذي اختص بالتهجم الدائم على البطريركية المارونية، من دون مراعاة أن تلك النبرة وهذا النسق العدائي يصيبان بطريقة من الطرق ثابتة “العيش المشترك” التي لعبت المرجعية الشيعية قبل زمن “الثنائي” دوراً في إثرائها بأبعاد فلسفية وتاريخية فريدة.
كان ذلك زمن رئيس “المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى” الإمام محمد مهدي شمس الدين والذي بغيابه حصل انقلاب فكري ووطني لن يكون بلا أثمان إذا استمر، ولقد حذر شمس الدين الشيعة في لبنان والمنطقة من أن يكونوا “مصدر خوف للآخرين، لأن الخوف منا لا يجعلنا متناقضين مع الأنظمة، بل يجعلنا، وهذا اسوأ ما يكون، على تناقض مع الشعوب بالذات”.
ومن الدلالة على أخطار تهدد “الميثاق” التفتيش الدائم عن “وصايا” الإمام شمس الدين، لحماية الشيعة من القابضين هذه الأيام على قرار “البيت الشيعي” اللبناني، وهو تفتيش يحمل في طياته محاولات لقطع دابر القطيعة التي تطل برأسها تحت أستار عناوين احتكار الشرف والوطنية، وحتى لا تنطفئ جذوة الأمل بـ”الميثاق الوطني” الذي كان الإمام شمس الدين أحد أعمدته عندما قال إن “في لبنان مشروعاً إسلامياً بالمعنى التنظيمي لا يمكن أن يكون”.