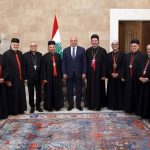تصدق مقولة “شر البلية ما يضحك” في وصف حال العمال في لبنان، حيث تحوّل “اليوم العالمي للعمال” إلى موضوع للسخرية في هذه البلاد التي تعاني أسوأ الأزمات في القرن الـ20 وانهياراً مالياً واقتصادياً غير مسبوق وتحللاً لهيكل الدولة. فمنذ عام 2019، خسر العمال مدخراتهم وودائعهم في المصارف، وتعرض كثيرون منهم للصرف من الخدمة بحجة التقشف وعدم تحمل المؤسسة أعباء مالية إضافية، فيما اضطر آخرون إلى القبول بشروط أصحاب العمل، والتنازل عن حقوقهم في التقديمات العائلية والصحية والضمان الاجتماعي. ويختصر أحد المواطنين المشهد لـ”اندبندنت عربية” بالقول إنه “في لبنان، يجب إعلان يوم للعاطلين من العمل” في إشارة إلى ارتفاع نسبة البطالة، غامزاً من المنافسة غير المتوازنة مع اليد العاملة الأجنبية الرخيصة.
وظيفة واحدة لا تكفي
دفعت الأزمة الاقتصادية وانهيار الأجور والقدرة الشرائية للمواطن إلى بروز نموذج “الوظيفة الثانية” و”العمل الموقت” والعمل الجزئي”، وهذه المرة وفق الصيغة اللبنانية، فهي تأتي لتشكل مرادفاً للعمالة غير النظامية، إذ لا يحظى الأجير بأي حماية قانونية أو استقرار وظيفي أو ضمانات اجتماعية. واتسعت ظاهرة قيام موظفي القطاع العام، بشقيه المدني والعسكري، بأداء وظيفة ثانية. وتقدم قصة العسكري زاهر (32 سنة) والأب لطفلين، صورة عن معاناة الموظف الرسمي في لبنان، بحيث يضطر خلال أيام إجازته إلى الركوب خلف مقود سيارته والعمل كسائق أجرة. ويؤكد زاهر أن الراتب لا يكفيه لتأمين الحاجات الأساسية للعائلة من مأكل ومشرب، وهو عاجز عن دفع إيجار منزله، لذلك فهو يعمل لبعض الساعات يومياً كسائق أجرة لزيادة مدخوله، وتتكرر قصص مشابهة على ألسنة كثيرين، إذ عاد بعضهم للعمل في الزراعة والبناء، كما انتشر العمل في خدمات التوصيل و”التجارة أونلاين” (عبر الإنترنت).
تنسحب المشكلة على عمال القطاع الخاص، وبدا لافتاً أن المعاناة تتكرر لدى موظفي المصارف الذين تربطهم بالمؤسسات عقود عمل جماعية، تتيح لهم من حيث المبدأ الضغط على المؤسسات المصرفية لتحسين أوضاعهم. ويصف نقيب موظفي مصارف لبنان جورج الحاج وضع الموظفين بالمأسوي لأن أجورهم بالليرة اللبنانية، والمساهمات (الإعانات) التي تقدمها المصارف لهم لا تحل الأزمة لأن المستحقات على الموظفين أكبر بكثير من الأجور”، متخوفاً من “عدم وجود أفق للحل السياسي القريب من دون انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة فاعلة وبرنامج عمل لمعالجة الأزمة الاقتصادية وإعادة الودائع لأصحابها، لكي تستعيد المصارف ثقة اللبنانيين”. ويقول الحاج “بما أن القطاع ليس بخير، فإن الموظفين ليسوا بخير كذلك”، مقراً بتراجع الخدمة المصرفية بسبب غياب الحافز لدى الموظف.
أرقام غير مبشرة
تقدم أرقام المسح الذي أجراه جهاز “الإحصاء المركزي” بالتعاون مع “منظمة العمل الدولية”، مجموعة معطيات ذات الدلالة حول سوق العمل في لبنان. فمن جهة، تستمر مستويات البطالة في الارتفاع، وكذلك العمالة غير النظامية وحال اللامساواة بين الرجال والنساء، إذ بيّن البحث الذي درس عينة فعلية من 5444 أسرة في مختلف المحافظات، أن الرجال نشطون في سوق العمل أكثر من النساء، فتبلغ نسبة الرجال 66.2 في المئة، مقابل 22.2 في المئة من النساء. وبحسب المسح، قفز معدل البطالة في لبنان من 11.4 في المئة في فترة 2018 – 2019 إلى 29.6 في المئة، وهذه النسبة مرشحة للزيادة في ظل تعمّق الانهيار الاقتصادي. أما العمالة غير المنظمة التي لا تغطيها بصورة كافية الترتيبات الرسمية ونظم الحماية، فتمثل الآن أكثر من 60 في المئة من العمالة في لبنان بحسب الإحصاء المركزي. وتوصل المسح إلى أن نحو نصف القوى العاملة والقوى العاملة المحتملة في لبنان، استخدمت بصورة ناقصة، إذ يكون الأشخاص متاحين للعمل لساعات أطول من العادة، وارتفعت نسبة العاملين من 16.2 في فترة 2018 – 2019 إلى 50.1 في عام 2022.
نحو قانون جديد للعمل
يشكل إصلاح قانون العمل مقدمة لحل أزمة سوق العمل والعمالة في لبنان، ومن المفارقة أن القانون الذي ما زال مطبقاً في البلاد هو ذاك الذي أُقر عام 1946 والذي ظهر في ظل نظام اقتصادي مختلف وأنماط إنتاج مختلفة، وجاء تكريساً لفلسفة قانون العمل الداعية إلى إنصاف الأجراء والحد من التفاوت الاقتصادي بينهم وأصحاب العمل. ويشدد المدير التنفيذي للمرصد اللبناني لحقوق العمال والموظفين الدكتور أحمد الديراني على ضرورة إقرار “التعديل الشامل لقانون العمل” لأن “مطلب إحالة القانون الحالي على التعاقد، لا يعني العيش من دون قانون، وإنما وضع قانون عمل إنساني عادل وعصري يواكب التطورات”، مبرراً ذلك بجملة أسباب، فالقانون الحالي “لا يتضمن سياسات وآليات توفر وتحمي الحق في الوصول إلى العمل”، لأن “تشريعاته ومواده باتت متخلفة جداً عن تشريعات العمل الدولية ومعايير العمل اللائق والعدالة الاجتماعية”.
ويضيف الديراني أن القانون القائم في لبنان “لا يواكب المتغيرات في سوق العمل التي شهدت ولادة فئات عمالية وقطاعات جديدة لا يلحظها القانون، على غرار عمال التطبيقات والتوصيلات، الدليفري، ونشوء أنواع جديدة من علاقات العمل، مثل العمل عن بعد، وعقود العمل الجزئية والموقتة، والعقود الاستشارية وغيرها”. ويردف أن “قانون العمل القائم لا يوفر بيئة عمل سليمة، ولا يحمي من الإصابات والحوادث والأمراض المهنية التي تصيب العمال بسبب العمل. وهو قانون لا يتضمن آليات رقابة فاعلة وملزمة تجاه تطبيق أحكامه”.
إلى ذلك، وضع “المرصد اللبناني لحقوق العمال والموظفين” ورقة عمل تضمنت تسليط الضوء على جملة ثغرات، لا بد للقانون الجديد من تجاوزها، انطلاقاً من القانون الحالي الذي “لا يشمل جميع العمال والعاملات، فهو يستثني العاملين في الخدمة المنزلية والعاملين في الزراعة والمياومين والأجراء في البلديات والمؤسسات العامة، ولا يحقق المساواة لا سيما في فرص العمل والأجور والترقية للنساء، ولا يحمي العمال والعاملات الأجانب، ولا يلحظ وجود المعوقين حركياً وذوي الحاجات الخاصة كفئة فاعلة في سوق العمل ولا يحميهم. وما زال عمال قطاع البناء والأشغال العامة في القطاعين العام والخاص خارج أي حماية قانونية”. وتطرقت الورقة كذلك إلى “الحماية من التنمر والتحرش الجنسي والمساواة بين العمال كافة من دون أي تمييز، وإلى عدم لحظ العمالة غير النظامية والمحرومة من جميع التقديمات الصحية والاجتماعية والقانونية”، و”لا يؤمن القانون الحالي استقرار العمل وديمومته، ولم يحدّث آليات حماية الأطفال من الاستغلال، ولم يضع تشريعات جديدة للحد من عمالة الأطفال”.
من هذا المنطلق، تشكل ورقة المرصد بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني محاولة لإطلاق حوار اجتماعي، تمهيداً لوضع مشاريع تؤدي إلى تعديل شامل للقانون.
الدولة القوية هي الحل
خلال أعوام الأزمة، لم تتخذ السلطات اللبنانية أي إجراء جدي لتحسين وضع العمال، واقتصر الأمر على رفع الحد الأدنى الرسمي للأجور إلى قرابة 200 دولار أميركي، وهو فعلياً لا يشكل خطوة نحو تحسين وضع العمال، فهو لم يصل بعد إلى نصف ما كان عليه قبل الانهيار عندما كان يساوي 675 ألف ليرة لبنانية، أي ما يعادل 450 دولاراً أميركياً. فيما تزداد الشكوى من غياب أجهزة التفتيش، وكذلك توقف مجالس العمل التحكيمية (قضاء العمل) عن النظر في الدعاوى بسبب توقف مفوضي الحكومة عن العمل.
ويعتبر الدكتور أحمد ديراني أن “وضع العمال في لبنان يشكل انعكاساً لحال التحلل التي يشهدها الكيان اللبناني، واضمحلال مؤسسات الدولة وأجهزتها”، إذ تعجز الأجهزة ذات الطابع القضائي والرقابي والتفتيش عن إلزام المؤسسات تطبيق موجباتها وفق مندرجات قانون العمل. من جهة أخرى، يشير الديراني إلى ضرورة شمول قانون العمل الجديد لعمال التطبيقات الذين أصبحوا يمثلون شريحة كبيرة من العمال، وعدم الخضوع لأرباب العمل والشركات الكبرى، لأنهم “ليسوا مقاولين يعملون لحسابهم الخاص ويخضعون لشروطهم، لأنه يعمل لمصلحة التطبيق والمشغّل، ونظامه. لذلك، فإن فرنسا اعتبرتهم أجراء، تحق لهم الإجازة والانتساب إلى الضمان”، ناهيك عن “إنصاف الفريلانسر (العامل الحر) في قطاع الصحافة والإعلام الذي لا يتمتع بالتأمينات والحماية”، وكذلك “العمل عن بعد الذي يوفر على أصحاب العمل نفقات التشغيل التي أصبحت تقع على عاتق الأجير”.
ويقترح الديراني “شمول قانون الضمان الاجتماعي المواطنين كافة من أجل حماية الفئات الأكثر هشاشة، تحديداً أصحاب العقود الموقتة والجزئية، وإلزام أصحاب العمل تسجيلهم”، منتقداً “استغلال ضعف الثقافة الحقوقية لدى العمال” و”القصور في عمل مجالس العمل التحكيمية إذ تستغرق الدعوى وقتاً طويلاً بين ثلاثة وخمسة أعوام، فيما يفترض القانون إنجازها وفق أصول العجلة خلال ثلاثة أشهر”. ويطالب بوضع نظام للتقاعد وتعويض للبطالة و”عدم الخضوع للنموذج النيوليبرالي المتوحش”، متسائلاً “أين أصبح قانون التقاعد والحماية الاجتماعية الذي يمنح معاشاً تقاعدياً لموظفي القطاع الخاص؟ وكم من الوقت تحتاج المراسيم التنظيمية إلى إقرارها؟”.