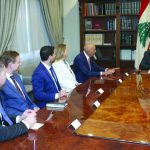لا بد للمرء أو لأي مراقب أن يضيع بين المسارين. وهذا الضياع غالباً ما تنتجه السياسة الأميركية منذ سنوات طويلة. ولكن بهدوء، لا بد من العودة إلى كل مراحل التصعيد الأميركي بالمواقف أو بالاستعراضات العسكرية ضد إيران والتي كانت تترافق مع مفاوضات من شأنها أن تقود إلى اتفاقات مرحلية وجزئية أو اتفاقات ذات مدى أبعد وأوسع. منذ ما قبل الاتفاق النووي في العام 2015، وما سبق وتلا التهديد “الأوبامي” في توجيه ضربة عسكرية للنظام السوري على خلفية استخدامه للأسلحة الكيميائية ومن ثم التراجع عن الضربة، إلى مراحل كثيرة من تقاطعات المصالح بين الأميركيين والإيرانيين تجلت في مراحل سابقة على الساحة العراقية بالانقلاب على نتائج الانتخابات وفوز إياد علاوي بها في العام 2010، والاتفاق على ترئيس نوري المالكي للحكومة.
كل التحشيد العسكري أو التصعيد الكلامي، كان غالباً ما يترافق مع تفاهمات موضعية، وعلى الأرجح هذا ما يحصل في هذه المرحلة، إذ لجأت واشنطن إلى التصعيد في وجه إيران ما شكّل مظلّة للإعلان عن الاتفاق الجزئي. ومن المفارقات التي أصبحت معروفة وربما ملّها العالم ولكن لا بد من الإشارة إليها، هي مصادفات متعددة، حول تجدد أنشطة غب الطلب لتنظيم داعش على وقع “التصعيد الأميركي بوجه طهران” بالتزامن تماماً مع البحث عن تفاهمات. فسريعاً، برز نشاط تنظيم داعش في البادية السورية، وفي أحد المقامات في مدينة شيراز. وعلى وقع التفسيرات الكثيرة حول الأهداف من التحشيدات الأميركية باتجاه العراق وسوريا، والتحليلات الأكثر التي أشارت إلى أن ذلك يندرج في خانة استعداد أميركا لتصعيد عسكري ضد الجماعات الموالية لإيران، كانت داعش تفعل من نشاطها، فيما تعلن وزارة الدفاع الأميركية أن تحرك قواتها العسكرية في سوريا والعراق لا علاقة له بإغلاق الحدود ولا بتطويق النفوذ الإيراني، بل بمحاربة تنظيم داعش.
يأتي ذلك، في ظل المساعي الأميركية لإعادة ترتيب العلاقات مع دول الخليج، بإرسال تلك التحشيدات العسكرية أو بتقديم عروض سياسية، ولكن بدون اتخاذ موقف أميركي حاسم في وجه إيران، والسعي إلى عرقلة أي مسار للتفاهم السعودي الإيراني. في المقابل، مارست واشنطن ضغوطاً على الدول العربية لوقف مسار التطبيع مع النظام السوري، وسط تضارب في المعلومات حول تجميد هذا المسار أما إعادة إطلاقه دبلوماسياً في المرحلة المقبلة من خلال تعيين سفير سعودي في دمشق. علماً أن النظام السوري لم يلتزم بأي من التعهدات التي قدّمها خلال فترة التفاوض معه حول العودة إلى الجامعة العربية.
بالإضافة إلى السياسات الأميركية المزدوجة، يأتي الاتفاق الأميركي الجزئي مع إيران، في ظل ممارسة واشنطن للمزيد من الضغوط على دمشق، ما يجعل الواقع السوري قابلا للانفجار الاجتماعي في أي لحظة، وخصوصاً في مناطق الساحل السوري بظل اشتداد الضغوط الاقتصادية والسياسية والتي تنتج أزمات اجتماعية ومعيشية متوالية. فيما ذلك يعمّق ارتهان النظام إلى إيران من خلال إغراقه بالديون والتي ستسترد بالعقود والاستثمارات والمزيد من السيطرة، على حساب العرب الذين كان الجانب الأساسي من تطبيعهم هو الدخول بقوة إلى سوريا والاستحواذ على استثمارات لاستعادة التوازن مع إيران، أو بناء على طموح بتحجيم نفوذها على المدى الأبعد.
إنها مرحلة جديدة من مراحل استمرار الأزمة السورية المستعصية على أي من الحلول. تبقى الصورة فيها ضبابية، بين تلويحات أميركية بالتصعيد أو إبقاء الوضع على حاله بناء على تفاهمات موضعية مع إيران من جهة، وسعي لترتيب العلاقة مع الخليج من جهة ثانية. تماماً كما حال علاقة واشنطن مع تركيا والتي تستمر المساعي لتحسينها وكان آخرها إعلان أنقرة عن وضع خطة لإعادة اللاجئين وتضمين مدينة حلب ضمن نطاق منطقة العمليات هذه بهدف إعادة اللاجئين إليها، في مقابل الحرص الأميركي على العلاقة وتقديم الدعم للقوى الكردية. كل ذلك لن ينتج حلولاً، ولا تغييراً في الوقائع أو قلباً للموازين. إنما هو قابل لإنتاج نموذج جديد لم تلحظه “العلوم السياسية وأسسها”. إنتاج دول فاشلة بشكل نهائي، قادرة على الاستمرار في وضعيتها الراهنة لأمد طويل بدون أن يشكل ذلك مخاطر عسكرية كبرى، باستثناء سوريا التي سيبقى العنف مستمراً فيها، لكن النموذج المقصود لا يقتصر على سوريا، إنما يشمل لبنان، العراق، اليمن، ليبيا، وقد يطول دولا جديدة تقوم على أساس “الفشل” بدون إنتاج العنف.